شرح المقدمة الآجرومية .. الدرس الخامس عشر

بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فها نحن مع
الدرس الخامس عشر من دروس شرح المقدمة الآجرومية . وكنا في الدرس السابق قد بدأنا
الكلام على القسم الأول من أقسام المعربات وهو ما يعرب بالحركات , وفي هذا الدرس
إن شاء الله تعالى سنكون مع القسم الثاني من أقسام المعربات وهو ما يعرب بالحروف .
الدرس الخامس عشر
المعربات بالحروف
قال رحمه الله : [ والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع ؛ التثنية , وجمع المذكر السالم
, والأسماء الخمسة , والأفعال الخمسة ؛ وهي يفعلان , وتفعلان , ويفعلون , وتفعلون
, وتفعلين ] ا.هـ
قوله [ والذي
يعرب بالحروف أربعة أنواع ] : الواو استئنافيةٌ ، والاسم الموصول مبني على السكون في محل
رفع صفة لمبتدأ مقدَّرٍ محذوف تقديره ( القسم ) أي
( والقسم الذي )
، و ( يعربُ )
فعلٌ مضارعٌ مبني للمجهول مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، ونائب
الفاعل ضمير مستترٌ جوازاً تقديره ( هو )
عائدٌ على الموصول والجملة صلته لا محل لها من الإعراب ، و ( بالحروف ) جارٌّ ومجرورٌ متعلقٌ بـ ( يعربُ ) ، و ( أربعةُ ) خبرُ المبتدأ المقدَّرِ مرفوعٌ وعلامة
رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضافٌ و ( أنواعٍ )
مضافٌ إليه مجرور بالإضافة .
ونفس التفصيل الذي ورد في باب علامات
الإعراب فيما يختص بما يعرب بالحركات هو نفس التفصيل في الباب ذاته فيما يختص بما
يعرب بالحروف . وقلنا أن المؤلف ــ رحمه الله ــ بدأ بما يعرب بالحركات لكون
الحركات هي الأصل في الإعراب .
فما يعرب من المعربات ويكون علامة
الإعراب فيه الحروف أربعة .
قوله [ التثنية ] : بدلٌ
عن أربعة مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره , فالمثنى يعرب بالحركات وسيأتي التفصيل
عليه بعد قليل . مثل قولك : ( جاء الطالبان مشياً )
. فـ ( جاء ) فعل ماضٍ مبني على الفتح , و ( الطالبان ) فاعل مرفوعٌ وعلامة رفعه الألف لأنَّه
مثنى , و ( مشياً )
حال منصوب .
قوله [ وجمع المذكر
السالم ] : الواو عاطفة , و ( جمع ) معطوف على بدلٍ وهو ( التثنية ) مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على
آخره ؛ وهو مضافٌ , و ( المذكر )
مضافٌ إليه مجرورٌ بالإضافة، و(السالم)
صفة لـ (جمع).
وقد سبق تعريفه معنا فيما مضى، ومثاله
قوله تبارك وتعالى: ]مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ[ [الأحزاب:23]. فـ(من المؤمنين) جارٌّ ومجرور في محل رفعٍ، خبر مقدم، و ( رجالٌ ) مبتدأ مؤخر مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة
الظاهرة على آخره، و(صدقوا)
صفة لـ (رجال).
قوله [والأسماء
الخمسة]: الواو عاطفة، و(الأسماءُ) معطوف على (التثنية) مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و(الخمسةُ) صفة للأسماء ومنهم من يراها بدلاً
والأول أوجه إن شاء الله تعالى.
قد مضى الكلام على الأسماء الخمسة في
باب علامات الإعراب بشيء من التفصيل وأنها من المعربات التي تكون علامة الإعراب
فيها الحروف، ولم يبق لنا سوى الكلام على لغاتها وشروط إعرابها بالحروف وكنا قد
وعدنا الإخوة المتابعين معنا لهذه السلسلة بالكلام على هذه الشروط ومذاهب العلماء
فيها؛ في موضعها وهو بعد قليل إن شاء الله تعالى.
فالأسماء الخمسة هي مما يعرب ويكون
علامة الإعراب فيه الحروف، مثل قولك: ( جاء أبوك، وزرتُ
أخاك، ومررتُ بحميها).
قوله [والأفعال
الخمسة]: تأخذ إعراب جملة
[الأسماء
الخمسة] قولاً واحداً.
ثم ذكرها مجملة، وهي باختصار كل فعل
مضارع ابتدأ بتاء أو ياء اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة؛ وكل فعل مضارع
ابتدئ بتاء فقط وكانت متصلة به ياء المخاطبة؛ لأنَّ المخاطبة لا يبتدؤ الفعل في
خطابها بياء فلا يقال (يفعلين) لأنَّ هذا غير
صحيح في اللسان العربي. فيكون عددها خمسة أفعال فقط ذكرها المؤلف -رحمه الله- بقوله: (يفعلان) للمثنى
الغائِبَيْنِ و(تفعلان)
للمثنى المخاطبَيْنِ. و(يفعلون)
للجمع الغائبِينَ و(تفعلون)
للجمع المخاطبِينَ. و(تفعلين)
للمفردة المخاطبة.
وبعد هذا الإجمال ؛ بدأ المؤلف ــ رحمه
الله ــ بالتفصيل , فقال :
[ فأمَّا التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء , وأمَّا جمع
المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء , وأمَّا الأسماء الخمسة فترفع
بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء , وأمَّا الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب
وتجزم بحذفها ] ا.هـ
قوله [ فأمَّا
التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء ] : الفاء هي الفصيحة وأمَّا حرف شرطٍ
وتفصيل , و ( التثنية )
مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره , ( فتُرْفَعُ ) الفاء واقعة في جواب الشرط و ( تُرْفَعُ ) فعلٌ مضارع مبني للمجهول مرفوعٌ وعلامة رفعه
الضمة الظاهرة على آخره ونائبُ الفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديرة ( هي ) عائدٌ على التثنية ؛ وجملة الفعل
ونائب الفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ , والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب
الشرط أمَّا . و ( بالألف )
جارٌّ ومجرور متعلق بـ ( تُرْفَعُ )
. ( وتنصب ) الواو عاطفة ( تنصب ) فعلٌ مضارعٌ مبني للمجهول ونائب
الفاعل ضميرٌ مستترٌ جوازاً تقديره هي عائدٌ على التثنية , وجملة الفعل ونائب
الفاعل في محل رفع خبر ثانٍ للمبتدأ . ( وتخفض )
تأخذُ نفس الإعراب , و ( بالياء )
جارٌّ ومجرور اختلف في متعلقه هل هو ما جاء بعده أم ماكان سابقاً بالأولية ,
فالبصريون يرون تعلقه بتنصب على الأولى عندهم ويقدر مثله لتخفض . وخالفهم الكوفيون
في ذلك فرأوا تعلقه بتخفض على الأولى عندهم ويقدَّرُ مثله لتنصب , ولعل قول
البصريين أقرب إن شاء الله لسبق تعلق الجارِّ والمجرور بتنصب في السياق .
والمثنى هو لفظٌ دالٌّ على اثنين ,
بزيادة في آخره صالحٌ للتجريد , وعطف مثله عليه .
وسبق أن نبهنا الإخوة القراء إلى أنَّ
الحركات والحروف ما هي إلاَّ علامات على الإعراب وليست أسباباً . فقول بعض النحاة
المعربات ترفع بالضمة أو ترفع بالألف ؛ هذه من باب التغليب وطبع غلب على الأصل ,
وإلاَّ فالصحيح أنَّ الحركات والحروف هي علامات وليست عوامل داخلة على المعرب
فتؤثر في في إعرابه أبداً .
فالتثنية على إطلاق المصدر ويراد به اسم
المفعول , أي أنَّ ما يعرب ويكون علامة الإعراب فيه الحروف هي أربعة ؛ أولها
المثنى وهو ما يكون الألف فيه علامة على الرفع وليس عاملاً للرفع , وقد مثلنا له
بالمثال السابق معنا مطلع الكلام على القسم الثاني من المعربات وهو ما يعرب وتكون
علامة الإعراب فيه الحروف .
وأمَّا الياء فيكون علامة للنصب والخفض
في التثنية وذلك على حسب المثال وعلى حسب سياق الكلام وعلى حسب العامل الداخل على
المثنى , فإذا كان العامل الداخل على المثنى هو عامل نصبٍ كالفعل أو إنَّ وأخواتها
كان منصوباً .
مثل قولك : ( رأيْتُ
الطالبّيْنِ ) رأيْتُ فعلٌ
ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضميرٌ متصلٌ مبني على الضم
في محل رفع فاعل , و ( الطالِبَيْنِ )
مفعولٌ به منصوبٌ وعلامة نصبه الياء لأنَّه مثنى . وقولك : ( إنَّ الطالبَيْنِ مجتهدان ) . وإذا كان العامل الداخل على المثنى
هو عامل جرٍّ كدخول حرف الجَرِّ على المثنى أو تأثره بالإضافة أو التبعية , ( مررتُ
بالطالبينِ المجتهدَيْنِ )
( مررْتُ ) مررْ فعلٌ ماضٍ مبني على السكون
لاتصاله بضمير رفعٍ متحرك والتاءُ ضميرٌ متصلٌ مبني على الضم في محل رفع فاعل , ( بالطالبين ) الباء حرف جرٍّ و ( الطالبَيْنِ ) اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى
, والجارُّ والمجرور متعلقان بمررتُ , و ( المجتهدَيْنِ )
صفة للطالبين مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى .
ومثل قوله تعالى : [فَكَانَ لِغُلَٰمَيۡنِ يَتِيمَيۡنِ] [ الكهف : 82 ] , الفاء
واقعة في جواب شرط لأمَّا في الآية , ( فَكَانَ ) الفاء رابطة ، و ( كان ) فعل ماضٍ ناصٌ , ( لِغُلَٰمَيۡنِ )
اللام حرف جرٍّ وغلامَيْنِ اسم مجرورٌ وعلامة الياء لأنَّه مثنى والجار والمجرور
في محل نصب خبر كان , واسمها ضميرٌ مستترٌ تقديره ( هو ) عائدٌ على الجدار , و ( يَتِيمَيۡنِ )
صفة لغلامين .
وهذا الإعراب في المثنى ينطبق على ما
ألحق به مثل : ( كلا و كلتا و اثنان و اثنتان ) ونحوها .
قال ابن مالك رحمه الله :
بالألف ارفع المثنى
وكلا إذا بمضمر
مضافاً وصلا
كلتا كذاك اثنان
واثنتان كابنين
وابنتين يجريان
وتخلفُ اليا في
جميعها الألف جرًّا
ونصباً بعد فتح قد أُلفْ
ويدخل في المثنى وما ألحق به ؛ لغة بني
الحارث بن كعب وبني العنبر وبني هجيم ، وبطون من ربيعة وخثعم وهمدان وعذرة وقبائل
أخر , وهي لزوم الألف رفعا ونصباً وجراًّ , وإن كان قد أنكرها المبرد لكنه محجوج
بنقل الأئمة .
ومنه قول الشاعر :
فأَطْرَقَ إِطْرَاقَ
الشُّجَاعِ , وَلَوْ رَأَى مَسَاغاً
لِنَابَاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا
والشاهد من البيت
قوله : ( لِنَابَاهُ ) .
كذلك منه وجه حمل عليه إعراب قوله تبارك
وتعالى : [إِنۡ
هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ] [
طه : 63 ] .
ومنه قول أبي النجم العجلي :
وَاهًا لِرَيَّا
ثُمَّ وَاهاً وَها يَا
لَيْتَ عَيْنَاهَا لَنَا وَفَاهَا
وَمَوْضِعَ
الْخَلْخَالِ مِنْ رِجْلاَهَا بِثَمَنٍ نُرْضِي بِهِ أَبَاهَا
ومنه قول الشاعر كذلك :
تَزَوَّدَ مِنَّا
بَيْنَ أُذْنَاهُ طَعْنَةً دَعَتْهُ
إِلَى هَابِي التُّرابِ عَقِيمِ
قال ابن عقيل في شرح الألفية : [ ومن العرب من
يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقًا : رفعًا ونصبًا وجرًّا ، فيقول : جاء
الزيدان كلاهما ، ورأيت الزيدان كلاهما ، ومررت بالزيدان كلاهما ] ا.هـ
قوله [ وأمَّا جمع
المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء ] : هذه الجملة تأخذ إعراب ما قد سبقها
. وأما قوله جمع المذكر السالم ؛ فإنه مما يعربُ ويكون علامة الإعراب فيه الحروف ,
وله ثلاث حالات إعرابية . فجمع المذكر السالم وما حُمِلَ عليه يرفع ويكون علامة
الرفع فيه الواو وينصب ويجر ويكون علامة الإعراب فيه الياء ، ومنه قول ابن مالك :
وارفع بواو وبيا اجرر
وانصب سالم جمع
عامر ومذنب
وجمع المذكر السالم على قسمين :
ما كان جامداً كعامر ويجمع على ( عامرون ) , وصفة كمذنب ويجمع على ( مذنبون ) .
فيشترط في إعراب الجامد :
1. أن يكون علماً , فخرج به ما لم يكن
علماً مثل : ( رجل )
فلا يقال ( رجلون )
. إلاَّ إذا صُغِّرَ مثل ( رُجَيْلٌ )
فيجمع ( رُجَيْلُونَ ) لأنَّه يصير وصفاً , ومنه قول الشاعر :
زَعَمَتْ تَمَاضُرُ
أَنَّنِي إمَّا أَمُتْ يَسْدُدْ
أُبَيْنُوهَا الأَصَاغِرُ خُلَّتِي
والشاهد من البيت قوله : ( أُبَيْنُوهَا ) جمعُ مصغر ( ابن ) .
2. وأن يكون لمذكرٍ وخرج به ما كان غير
مذكر كهند فلا يقال ( الهندون ) .
3. وأن يكون لعاقلٍ وخرج به غير العاقل
فلا يجمع على نحوه .
4. وأن يكون خالياً من تاء التأنيث مثل
: ( حمزة ، طلحة )
ونحوها . وأجازه الكوفيون بعد حذف تاء التأنيث وذكروا لذلك ثلاثة أدلة :
1. أنه علم على مذكر وإن كان لفظه لمؤنث
؛ قالوا والعبرة بالمعنى لا باللفظ .
2. أن هذه التاء في تقدير الانفصال
بدليل سقوطها في جمع المؤنث السالم في قولهم : (حمزات
و طلحات )
.
3. أن الإجماع منعقدٌ على جواز جمع
العلم المذكر المختوم بألف التأنيث جمع مذكر سالماً وهو أشدُّ تمكناً في التأنيث
من المختوم بتاء التأنيث , فإذا جاز جمع الاسم الأشد تمكناً في التأنيث جمع مذكر
سالماً ؛ جاز جمع الاسم الأخف تمكناً في التأنيث جمع مذكر سالماً من باب أولى .
5. وأن يكون خالياً من التركيب كذلك ,
فلا يجمع المركب جمع مذكر سالماً مطلقاً , وهذا مذهب الجمهور , وأجاز بعضهم ذلك ؛
مثل : ( سيبويه ) فجمعوا جملته فقالوا ( سيبويهيون ) , وقال بعضهم بل يجمع صدره فقالوا ( سيبيون ) .
وأمَّا المركب تركيباً إسنادياً فأنَّه
محل إجماع على عدم جمعه جمع مذكر سالماً .
وأمَّا ما كان صفة فلا يجمع جمع مذكرٍ
سالماً إلاَّ بشروط ؛ وهي :
1. أن يكون صفة لمذكر ؛ فخرج به ما كان
صفة لمؤنث مثل قولك : ( حائض ، عاقر ) فلا يصح أن تقول : ( حائضون ، عاقرون )
, وخرج به أيضاً ما استوى في المذكر والمؤنث ؛ مثل قولك : ( صبورٌ ، جريحٌ )
فتقول ( رجلٌ
صبورٌ و امرأة صبورٌ )
فلا يصح أن تقول : ( صبورون ، جريحون ) .
2. وأن يكون صفة لعاقل , فخرج به
ما كان صفة لغير العاقل , مثل قولك : ( سابق )
في وصف الفرس ؛ فلا يصح أن تقول : ( سابقون )
.
3. أن يكون خالياً من تاء التأنيث ؛
فخرج به ما ختم بتاء التأنيث , مثل قولك : ( علاَّمَةٌ ، فهَّامة )
؛ فلا يصح أن تقول : ( علاَّمون ، فهَّامون )
.
4. ألاَّ يكون من باب ( أَفْعَلَ
فَعْلاَءَ ) ؛ مثل قولك : ( أَبْيَضُ
بَيْضَاءَ ) ؛ فلا يصح أن
تقول : ( أبيضون ) .
5. ألاَّ يكون من باب ( فَعْلاَنَ
فَعْلَى ) ؛ مثل قولك : ( نَشْوَان
نَشْوَى ) ؛ فلا يصح أن
تقول : ( نشوانون ) .
فمكان جمع مذكر سالم فهو إمَّا جامدٌ
وانبطبقت عليه شروطه كـ ( عامر )
يجمع على ( عامرون )
, وإمَّا أن يكون صفة وانطبقت عليه شروطه كـ ( مذنب )
يجمع ( مذنبون ) .
فما أشبه الجامد من حيث الشروط جُمِعَ
جمع مذكر سالماً ولا شك , مثل قولك ( محمد ، عليٌ ، زيدٌ ) ؛
فتقول : ( محمدون ، عليون ، زيدون ) .
ومثله ما أشبه الصفة من حيث الشروط كذلك
, مثل قولك : ( الأفضل , الأقرب ) , فتقول : ( الأفضلون ) ومثل قوله تعالى :[ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ] [ البقرة : 180 ] .
كذلك ما ألحق بجمع المذكر السالم ,
فإنَّه يأخذ حكمه في كون الواو علامة له في الرفع والياء علامة له في النصب والجر .
قوله [وأمَّا
الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء] : مضى معنا إعراب
الجملة فيما سبقها آنفاً .
فالأسماء الخمسة قلنا أنَّها عند
البصريين ستة بإضافة ( هنُ ) ؛
وعند الكوفيين خمسة فقط ؛ كون اعتبار الأفصح في ( هنُ ) هو إعرابه بالحركات لا الحروف . فهذه
الأسماء الخمسة تعرب بالحروف , فترفع ويكون علامة الرفع فيها الواو ؛ مثل قولك : ( جاء أبوك ) , وتنصب ويكون علامة النصب فيها الألف
؛ مثل قولك : ( رأيتُ أخاك )
, وتجرُّ ويكون علامة الجرِّ فيها الياء ؛ مثل قولك : ( مررتُ بحميها ) .
ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله :
وارفع بواوٍ وانصبنَّ
بالألف واجرر
بياءٍ ما من الأسما أصف
ويعني بها الأسماء الخمسة وهي ( أبٌ ، أخٌ ، حمٌ ، فو ، ذو مال ) .
ولكن علماء النحو ذكروا لإعرابها
بالحروف شروطاً ؛ هنا أوان ذكرها كما وعدنا الإخوة القراء ؛ وقبل بيان شروطها لا
بد أن نعلم أنَّ في هذه الأسماء الخمسة لغات لعلنا نذكرها .
1. لغة الإتمام , وهي أن تعرب جميعها
بالحروف كما هي , فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء .
2. لغة النقص وهي خاصة بــ ( أبٍ ، أخٍ ، حمٍ ، هنٍ ) ,
وهي حذف الواو والألف والياء منها , وتقتصر في إعرابها على الحركات الظاهرة
كعلامات إعرابٍ لها على الباء والخاء والميم والنون , مثل قولك : ( جاء أَبُهُ ، رأيتُ أَخَهُ ، مررتُ
بحَمِهَا ) , مع كون النقص
هو الأحسن في ( هنِ ) ,
ونادرٌ حصوله في ( أبٍ ، أخٍ ، حمٍ ) .
ومن شواهد هذه اللغة ؛ لغة النقص ؛ قول
رؤبة بن العجاج :
بِأَبِهِ اقْتَدَى
عَدِيٌّ في الكرمْ ومَن
يُشَابِهْ أَبَهُ فمَا ظَلَمْ
3. لغة الإلتزام , وهي لزوم الألف
مطلقاً في ( أب ، أخ ، حم ) في
جميع حالات الإعراب الثلاث ؛ رفعاً ونصباً وجرًّا . مثل قولك : ( جاء أباك ، رأيتُ أخاك ، مررتُ
بحماها ) .
ومن شواهد هذه اللغة ؛ ما عزاه أبو
الغول لبعض أهل اليمن :
إنَّ أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها
ومنه كذلك قوله :
واشْدُدْ بِمَثْنَى
حَقَبٍ حِقْوَاهَا ناجِيَةً
وناجِياً أباها
وأما شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف
فهي كما يلي :
1. أن تكون ( ذو ) مفيدة للصحبة أو الملك , فإن جاءت ذو
طائية ــ أي بمعنى ( الذي )
ــ خلت من هذا الإعراب , وتكون مبنية غير معربة . مثل قول الشاعر :
فإمَّا كرامٌ
موسِرونَ لقيتهم فَحَسْبِيَ
مِن ذو عندَهم ما كفانيا
2. أن تخلو ( فمٌ ) من الميم في آخرها , فتكون ( فو ) .
وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله :
من ذاك ( ذو ) إنْ
صحبةً أبانا والفمُ
حيثُ الميم منه بانا
3. أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم ,
فخرج بهذا إذا كانت مجردة من الإضافة فعند عدم إضافتها تكون مجردة وتعرب بالحركات .
4. ألاَّ تضاف إلى ياء المتكلم , فخرج
بهذا إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فعندئذٍ تعرب بالحركات كذلك , مثل قولك ( جاء أبي ، رأيت أخي ، مررتُ
بحميِّي ) .
5. أن تكون مكبرة غير مصغرة , مثل قولك
: ( أُبَيٌّ ، أُخَيٌّ ، حُمَيٌّ ) .
6. أن تكون مفردة غير مثناة ولا مجموعة .
قوله [ وأمَّا الأفعال
الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها ]
: الأفعال الخمسة أو كما تعرف عند البصريين بالأمثلة الخمسة هي مما يعرب ويكون
علامات الإعراب فيها الحروف . وقد سبق معنا في باب معرفة علامات الإعراب أنها ترفع
ويكون علامة الرفع بها ثبات النون , وتنصب وتجزم ويكون علامة النصب والجزم بها حذف
النون ولا جرَّ بها .
وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام
على فصل أقسام المعربات , ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في
توضيحه . وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم على [ باب الأفعال ] , وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه أخوكم
أبو حمود هادي
محجب
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |



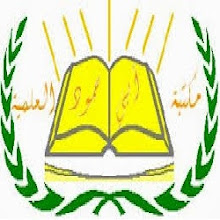






















0 التعليقات: