أصول الفقه دراسة تحليلية - الجزء الثاني . . .
بسم الله الرحمن الرحيم
فها نحن مع الجزء الثاني من هذه السلسلة - أصولُ الفقه دراسة تحليلية - والتي سيكون محور الحديث فيها عن مدارس أصول الفقه إن شاء الله تعالى .
فبعد أن تطرقنا في الجزء الأول لمقدمة في أصول الفقه ، بَيَّنَّا فيها تعريفه وموضوعه والثمرة المترتبة على دراسة هذا الفن الجميل .
سوف نستعرض في هذا الجزء من السلسلة تاريخ نشأة هذا العلم وأهم مدارسه ، فأقول مستعيناً بالله تبارك وتعالى :
ولا شكَّ أنَّ طلاب العلم يتفقون على ما قد مضى معنا في الجزء الأول من هذه السلسلة ؛ وهو أنَّ أول من وضع في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .
وهذا لا يعني بالضرورة أنَّ الإمام الشافعي هو واضع هذا العلم ابتداءً ، بل كانت قواعد هذا العلم موجودة ويتعامل بها في اجتهادات الصحابة والتابعين كذلك ، وظهرت قواعد أصولية فرعية كانت بمثابة النواة لهذا العلم ، عُدَّت أساساً في مبادئ الترجيح بين الأدلة المتعارضة ، ظهرت في قياس علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حدِّ السكران على القاذف . وفتوى ابن مسعود - رضي الله عنه - بأنَّ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ، لنزول سورة الطلاق وفيها بيان عِدَّة الحوامل ؛ متأخرة عن نزول سورة البقرة وفيها بيان عِدَّة المتوفى عنها زوجها ، فكان المتأخرُ من النصوص ناسخاً لما قبله أو مخصصاً له .
وكذلك من القواعد التي كان معمولاً بها عندهم ؛ تقديم المتواتر على الآحاد ، والخاص على العام ، والتحريم على الإباحة ، وتخصيص العام بالخاص ، وحمل المطلق على المقيد ، مثلُ قوله تبارك وتعالى : ⦕ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ ⦖(١) ، ومثلُ قوله تبارك وتعالى : ⦕ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمًا مَّسۡفُوحًا ⦖(٢) ، فحُملَ اللفظ المطلق في آية المائدة على اللفظ المُقَيَّدِ في آية الأنعام ، فكان الدَّمُ المحرَّم هو الدَّمُ المسفوح .
وكان كذلك لبعض التابعين وأئمة المذاهب قبل الشافعي قواعد وأصول يعتمدونها في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية واستنباطها ، ولا يزال العمل بهذه القواعد والأصول ، ولا تزال منقولة عنهم ، واضحةٌ معالمها في الاجتهادات المنقولة عنهم ، جرى بيانها على أيدي تلاميذهم من بعدهم في مصنفاتهم .
لكنَّ هذه القواعد لم تكن مجموعة بشكل علمي ومرتبة في مصنفٍ واحدٍ يضمها ، ولكنها كانت معلومة لديهم ومتعارفاً على العمل بها ومراعاتها في اجتهاداتهم . حتى جاء عصر الإمام الشافعي - رحمه الله - فكان أوَّلَ من صنف في هذا العلم مصنَّفاً علمياً جامعاً لبعض قواعد هذا العلم في كتابه الرسالة .
فتوالى التدوين والتصنيف في هذا الفن بعد ذلك ، فألَّفَ الإمام أحمد - رحمه الله - كتاب ( طاعة الرسول ) ، وكتاب ( الناسخ والمنسوخ ) ، وكتاب ( العلل ) . وألَّفَ غير واحدٍ من علماء الحنفية وعلماء الكلام في هذا الفنِّ . فأصلوا مناهج وقواعد علم أصول الفقه استنباطَ واستخراجَ واستخلاصَ الأحكامِ الشرعيةِ من أدلتها التفصيلية .
فنشأت بعد ذلك مدارس في أصول الفقه ، جاءت نتيجة لكثرة التأليف والتصنيف في هذا الفنِّ ، وتنوَّعت بحسب مشارب كل قومٍ في التلقي والاستسقاء .
ولكن قلَّ من يعلم من طلبة العلم وخاصة المبتدئين منهم أنَّ لعلم أصول الفقه مدارس شتى تعاقب ظهورها بعد ذلك .
وهذا لا يعني بالضرورة أنَّ الإمام الشافعي هو واضع هذا العلم ابتداءً ، بل كانت قواعد هذا العلم موجودة ويتعامل بها في اجتهادات الصحابة والتابعين كذلك ، وظهرت قواعد أصولية فرعية كانت بمثابة النواة لهذا العلم ، عُدَّت أساساً في مبادئ الترجيح بين الأدلة المتعارضة ، ظهرت في قياس علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حدِّ السكران على القاذف . وفتوى ابن مسعود - رضي الله عنه - بأنَّ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ، لنزول سورة الطلاق وفيها بيان عِدَّة الحوامل ؛ متأخرة عن نزول سورة البقرة وفيها بيان عِدَّة المتوفى عنها زوجها ، فكان المتأخرُ من النصوص ناسخاً لما قبله أو مخصصاً له .
وكذلك من القواعد التي كان معمولاً بها عندهم ؛ تقديم المتواتر على الآحاد ، والخاص على العام ، والتحريم على الإباحة ، وتخصيص العام بالخاص ، وحمل المطلق على المقيد ، مثلُ قوله تبارك وتعالى : ⦕ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ ⦖(١) ، ومثلُ قوله تبارك وتعالى : ⦕ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمًا مَّسۡفُوحًا ⦖(٢) ، فحُملَ اللفظ المطلق في آية المائدة على اللفظ المُقَيَّدِ في آية الأنعام ، فكان الدَّمُ المحرَّم هو الدَّمُ المسفوح .
وكان كذلك لبعض التابعين وأئمة المذاهب قبل الشافعي قواعد وأصول يعتمدونها في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية واستنباطها ، ولا يزال العمل بهذه القواعد والأصول ، ولا تزال منقولة عنهم ، واضحةٌ معالمها في الاجتهادات المنقولة عنهم ، جرى بيانها على أيدي تلاميذهم من بعدهم في مصنفاتهم .
لكنَّ هذه القواعد لم تكن مجموعة بشكل علمي ومرتبة في مصنفٍ واحدٍ يضمها ، ولكنها كانت معلومة لديهم ومتعارفاً على العمل بها ومراعاتها في اجتهاداتهم . حتى جاء عصر الإمام الشافعي - رحمه الله - فكان أوَّلَ من صنف في هذا العلم مصنَّفاً علمياً جامعاً لبعض قواعد هذا العلم في كتابه الرسالة .
فتوالى التدوين والتصنيف في هذا الفن بعد ذلك ، فألَّفَ الإمام أحمد - رحمه الله - كتاب ( طاعة الرسول ) ، وكتاب ( الناسخ والمنسوخ ) ، وكتاب ( العلل ) . وألَّفَ غير واحدٍ من علماء الحنفية وعلماء الكلام في هذا الفنِّ . فأصلوا مناهج وقواعد علم أصول الفقه استنباطَ واستخراجَ واستخلاصَ الأحكامِ الشرعيةِ من أدلتها التفصيلية .
فنشأت بعد ذلك مدارس في أصول الفقه ، جاءت نتيجة لكثرة التأليف والتصنيف في هذا الفنِّ ، وتنوَّعت بحسب مشارب كل قومٍ في التلقي والاستسقاء .
ولكن قلَّ من يعلم من طلبة العلم وخاصة المبتدئين منهم أنَّ لعلم أصول الفقه مدارس شتى تعاقب ظهورها بعد ذلك .
فكما أنَّ للفقه مدارس ؛ مدرسة الحديث ، ومدرسة الرأي ، كذلك انقسم علماء الأصول إلى مدارس متعددة ، ومسالك مختلفة ، فمنهم من سلك المنهج النظري في التأليف ، بدون الالتفات إلى الفروع التي تنبثق عن هذه القواعد ، وهذه المدرسة عُرِفَت بطريقة المتكلمين . ومنهم من سلك مسلك التأثر بالفروع التي نُقِلَت عن أئمتهم ، وهذه المدرسة عُرِفَت بطريقة الفقهاء والمراد بهم فقهاء الحنفية . وفي نهاية القرن السابع الهجري ؛ حاول المتأخرون الجمع بين المدرستين أو الطريقتين ، والتنسيق بين الجهدين ، فجاءت تصانيفهم جامعة بين الفائدتين .
ومحور الخلاف بين الطريقتين هو كيفية تقرير القاعدة ، هل تكون سابقة على الفروع والتطبيقات ؟ ، أم أنَّ الفروع والمسائل هي الأصل ؟ ، وأنَّ النظرية هي التابع ؟ .
وقد عُرِفَت بطريقة الشافعية ، لأنَّ الشافعي أول من نهجها ، وأكثر وأشهر من انتهجها كانوا شافعية ، والشافعية هم الذين سبقوا للكتابة فيها . كما عُرِفَت أيضاً بطريقة الجمهور ، لانتهاج أكثر الأصوليين من المذاهب الثلاثة - المالكية والشافعية والحنابلة - هذا النهج في تدوين الأصول .
كذلك عُرِفَت بطريقة المتكلمين ؛ لكونهم استمدوا مناهج دراستهم من علم الكلام ، ولأنَّ أكثر من كتب فيها كانوا من علماء الكلام ؛ الذين تأثروا بعقيدة الاعتزال تحديداً .
فاتجهوا اتجاهاً منطقياً نظرياً ، كثرت فيه الفروض النظرية ، فأخذوا يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ، ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن ، بمعنى أنَّ أصحاب هذه المدرسة قرَّرُوا قواعد الأصول المأخوذة من الأدلة النصية النقلية واللغوية والكلامية والعقلية .
وحققوها من غير نظر إلى الفروع الفقهية ، لأنَّ الأصول عندهم أسبق من الفروع ، وهذا اتجاه منطقي في تقرير القواعد الأصولية المستفادة من الأدلة المجرَّدة من غير تعصب لمذهب أو استنباط ما ، وحتى تكون ميزاناً لضبط الاستنباط ، ومعياراً لسلامة الاستدلال ، ومنطلقاً للاجتهاد المتحرر من المذهبية من غير أن يكون هناك أي تسلط للفروع المذهبية ، أو تسيير للنظر ، أو قيود لا خروج عنها ، فيكون الحكم للأصول على الفروع .
وقد درَجَ أصحاب هذه المدرسة على هذا المنهج والتزموا به ، فلم يأتوا على الفروع الفقهية إلَّا على سبيل التمثيل والإيضاح .
وأبرز خصائص طريقة المتكلمين تتلخص في خمس خصائص تقريباً :
أولاً : تحقيق المسائل وتقرير القواعد .
ثانياً : تمحيص الخلاف مع الاعتماد على الاستدلال العقلي المجرد .
ثانياً : تمحيص الخلاف مع الاعتماد على الاستدلال العقلي المجرد .
ثالثاً : الإكثار من الجدال في المسائل والقواعد على طريقة علماء الكلام .
رابعاً : عدم التعصب لمذهب فقهي معين .
رابعاً : عدم التعصب لمذهب فقهي معين .
خامساً : علاقتها مع الفروع الفقهية في حدود الإيضاح والمثال . بمعنى أنَّهم ليس لهم علاقة بالتطبيق إلَّا فيما نَدَر .
وكان لهذه الطريقة وخصائصِها أثرٌ كبيرٌ في استهواء كثير من الأصوليين في شتى العصور ، حيث بلغ ذروته في عصرنا الحاضر الذي أعطوا فيه للعقل مدى واسعاً جداً ، ويرى بعض الباحثين أنَّ هذه الطريقة أثرت ببحوث أصحابها علم أصول الفقه ، والتعمق في مدلولاته ، وبلورة قضاياه ومبادئه ، دون أن يكون للمسائل الفرعيَّة أيُّ أثرٍ عليها . متجهين اتجاهاً نظرياً خالصاً .
وبما أنَّ المتكلمين هم ممن تأثروا بالمناهج والعقائد التي تأثر أصحابها بكتب الفلاسفة وعلوم المنطق ، وعلوم الهند واليونان ، وتشربوا منهم تلك العقائد الفاسدة والباطلة ، فقد ظهر فسادها في مؤلفاتهم وإنتاجهم الفكري ، فظهرت كتبٌ ومؤلفات لا زالت إلى يومنا هذا تُعَدُ عُمَداً وأصولاً عند كثيرٍ ممن انحرفوا عن جادة السنة ، وعند أهل الكلام من شتى طوائف الإسلام . وعرفت هذه الكتب فيما بعد بكتب أهل الكلام ، وأهمها :
١. كتاب العهد للقاضي عبد الجبار المعتزلي .
٢. كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن الطيب البصري المعتزلي .
٢. كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن الطيب البصري المعتزلي .
٣. كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني .
٤. كتاب المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي .
وتتمثل هذه الكتب ملخصة في كتاب المحصول للفخر الرازي ، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .
ومن ثَّمَ توالت بعد ذلك الشروحات والمختصرات عليهما ، وظهرت بعد ذلك مختصرات على المختصرات وشروحات لمختصرات المختصرات .
وأكثر كتب الأصول نفعاً لطلاب العلم ؛ شرح مختصر الروضة للطوفي ، والبحر المحيط للزركشي ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي ، وإرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني .
طريقة الفقهاء ؛ والمراد بهم فقهاء الحنفية ، وقد نسبت إليهم لكونهم هم من التزموا الكتابة والتأليف بهذه الطريقة .
التزم أصحاب مدرسة الفقهاء خط سيرٍ نمطي تقريري لفروع أئمتهم ، قلَّ أن يحيد عنه أحدهم ، وتتلخص أهم خصائص هذه المدرسة فيما يلي :
أولاً : التزموا خط التأثر بالفروع .
ثانياً : بيان أن الأصول هي لخدمة الفروع .
ثالثاً : إثبات سلامة مبدأ الاجتهاد فيها .
رابعاً : قرروا فيها القواعد الأصولية على مقتضى ما نقلوه من فروع أئمتهم .
خامساً : ادعوا أنَّها القواعد التي لاحظها أئمتهم عند تفريع الفروع .
سادساً : صارت عندهم بمثابة أصول تأخر استخراجها عن وجود الفروع .
سابعاً : لذلك تجدهم يكثرون من ذكر هذه الفروع في كتبهم .
وعليه ؛ فمن أمعن النظر في مؤلفات الفقهاء في أصول الفقه ؛ يجد أنَّ أصولهم تختلف عن أصول الشافعية أو مدرسة المتكلمين . حيث يجد أصول المتكلمين وضعت منهجاً للاستنباط حاكمة عليه . أمَّا طريقة الفقهاء فإنَّها غير حاكمة على الفروع بعد تدوينها ، وبذلك استنبطوا القواعد التي تؤيد مذهبهم وهو الفروع المقررة من أئمتهم . فصارت القواعد عندهم مُقَرِّرَةً لا حاكمة .
وكما وجد لمدرسة المتكلمين كتبٌ ومؤلفات أعتبرت عمدة لدى سالكي هذه المدرسة فيما بعد ، كذلك وجدت كتبٌ ومؤلفات لدى أصحاب مدرسة الفقهاء اعتبروها عمدة لديهم وسلكوا على منوالها في التأليف ؛ لأنَّها تقرر منهجهم في أصول الفقه ، وهو تقرير القواعد لفروع أئمتهم التي درجوا عليها. ومن أهم هذه الكتب :
١. مآخذ الشرائع لأبي منصور محمد الماتريدي .
٢. أصول الجصاص لأبي بكر أحمد الجصاص .
٣. تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي ، وله كتاب تأسيس النظر .
٤. كنز الوصول إلى معرفة الأصول لفخر الإسلام أبي الحسن البزدوي .
وله شرحٌ يُعدُّ من أشهر شروحاته وهو كتاب كشف الأسرار لعلاء الدين عبد العزيز البخاري .
٥. أصول السرخسي ، لأبي بكر محمد السرخسي .
٦. ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي .
٧. منار الأنوار لأبي البركات حافظ الدين النسفي .
وبهذا نكون قد استوفينا الكلام على نشأة أصول الفقه وأهم مدارسه ، وأهم مؤلفات المدرستين . يبقى معنا أن نسلط الضوء على طريقة الجمع بين المدرستين ، وهذا سيكون في الجزء الثالث من هذه السلسلة إن شاء الله .
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه راجي عفو ربه
أبو حمود هادي محجب
السبت ٢٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) [ المائدة : ٣ ] .
(٢) [ الأنعام : ١٤٥ ] .
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |












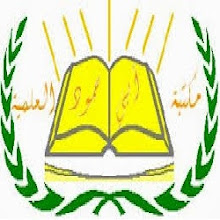






















0 التعليقات: